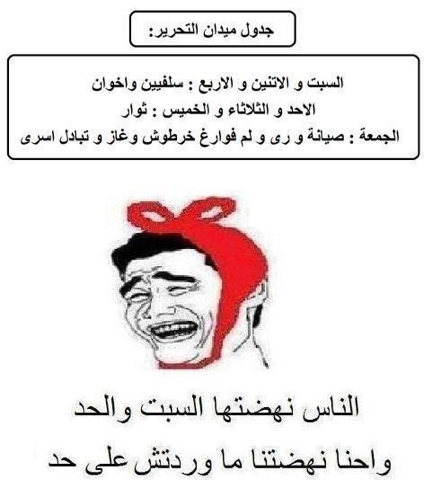ترددت في نشر هذا المقال، وخفت أن يُفهم أنه اصطفاف مع الرئيس واجراءاته ضد سلام فياض، وللأمانة أنا ضد سياسات الرجلين الذين تحالفا لسنوات وأوصلانا لما نحن فيه!
لماذا ألوم سلام فياض ولا ألوم الحمدلله؟
سلام فياض قدم نفسه صاحب رؤية ومشروع وفوق ذلك لديه أيديولوجية وفكر ليبرالي (بعيداً عن اقتصاد السوق المفتوح) يؤمن بالحريات والتعددية والديمقراطية. في حين أن الحمدلله لم يقدم نفسه إلا موظف عمومي ينفذ ما تم خطه لحكومته من مهمات أربع ليس عليه الاجتهاد ليضيف لها مهمة خامسة. الحمدلله- رئيس جامعة عريقة- لم يطلب منه أحد أن يقدم مشروع حكم ولا وجهة نظر في طبيعة النظام السياسي ولا طبيعة الحكم. الحمدلله جاء لاستكمال ما بدأه سلفه وتنفيذ ما يأمره به رئيسه ونقطة.
تعود محاولات تدجين واحتواء مؤسسات المجتمع المدني منذ وضعت السلطة أقدامها في غزة وأريحا، واستمرت المحاولات متخذة شكل قوانين ولوائح تنفيذية أو قرارت ادارية، ومرة على شكل تحريض ممنهج واتهامات بالارتباط بالخارج وبالأجندات الدولية، وبالتطبيع والتخوين، ومرة على شكل تكوين جمعيات ومؤسسات تابعة بشكل كامل ومرتبطة بجهاز امني أو حزب حاكم. ولكن ذروة الانقضاض على المجتمع المدني برزت منذ الانقسام الفلسطيني 2007 ليومنا هذا.
بدأت باعلان حالة الطوارئ- من قبل الرئيس- التي كانت تعني اطلاق يد الأمن في كل مناحي الحياة، تلاها قرار- غير قانوني- لرئيس الوزراء سلام فياض بحل وتجميد أرصدة 103 جمعية خيرية، بدون المرور بالاجراءات القانونية المتبعة، وبدون قرار محكمة وأطلقت يد وزير الداخلية للتدخل في مؤسسات المجتمع المدني.
رغم هذا التغول، صمت المجتمع المدني كثيراً- قيادته تحديداً- تجاه سياسات فياض الاقتصادية والأمنية، فمن جهة حُسِب لفياض انهاء حالة الفلتان الأمني التي سادت قبله، ومن جهة ثانية كان فياض يحمل شرعية دولية ودعم دولي يحتاجهما المجتمع المدني، كما قدر المجتمع المدني لفياض قبوله لمنصب في مرحلة تاريخية سوداء رفض أي مسؤول أن يسجل التاريخ اسمه فيها، والأهم أن فياض اهتم بعقد لقاءات دورية طويلة مع قيادات المجتمع المدني، وكتاب الرأي والصحافيين، لدرجة أن تخيل هؤلاء أنهم يؤثرون في صناعة القرار- بل أنهم جزء منه-، في حين أن فياض كان يستمع لهم ويمازحهم، وفي النهاية يعمل ما يراه هو!
فياض تنازل عن سيطرته على الأجهزة الأمنية في يوليو 2011- أو أُرغم على التنازل لصالح الرئيس-، فلا يمكن لوم من جاء بعده لعدم قدرته على استعادة هذه السيطرة على تلك الأجهزة التي لم يرى فياض (أثناء سيطرته عليها وبعد فقدانه للسيطرة) من ضرر في تخصيص موازنة تتراوح بين 30-38% من موازنة السلطة لصالحها على حساب الفئات المهمشة والقطاعات الأساسية، وتحديداً الزراعة لمجتمع فلاحي، رغم الخطاب الجميل للصمود ومواجهة الاستيطان، ورغم الانتقادات التي وجهها لمجتمع المدني ولا يزال، إلا أن الاستجابة صفر!
الهيمنة الأمنية لا تستوي واطلاق الحريات العامة، وهو ما يدركه أي ليبرالي صغير، الهيمنة الأمنية تعني تبرير الانتهاكات وصناعة نظام فردي –ديكتاتوري- يتناقض وخطاب بناء المؤسسات!
ولكن الهيمنة الأمنية تتساوق مع التنازل عن صلاحيات أقرها القانون الأساسي، وتتساوق مع تغييرات قانونية تطال حرية وعمل المجتمع المدني.
رغم ارتياح المجتمع المدني في الضفة لقرار الرئيس بقانون رقم (6) 2008 بشأن تعديل قانون الشركات، والذي أجاز للمرة الأولى تأسيس شركات غير ربحية، إلا أن النظام الذي جاء على شكل قرار لمجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010، جاء مخيباً للآمال وبعيداً عن روح قانون الجمعيات، حيث يضع الصلاحيات كافة في يد وزير الاقتصاد بتنسيب من مراقب الشركات. ورغم الاحتجاج الخجول، لم يتغير القانون!
وفي 2011، أصدر الرئيس تعديلاً على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بحيث يسمح بتحويل أموال الجمعيات التي يتم حلها لخزينة السلطة، رغم ان القانون الأصلي تحدث فقط عن تحويل الأموال والمنقولات لجمعية شبيهة.
وفي 2012، صدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل "هيئة شؤون المنظمات الأهلية" وعين على رأسها عضو لجنة مركزية لحركة فتح، في تجاوز لصلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في المادة (6) من القانون الأساسي، وهي ليست الهيئة الوحيدة التي تم تجاوز رئيس الوزراء، ولكن الأخير تنازل طوعاً عن صلاحياته تجاهها، ليرتبك المجتمع المدني مرة أخرى، تجاه هذا الاجراء غير المفهوم، وعلاقته بقانون الجمعيات والهيئات المرجعية التي حددها القانون من وزارة الداخلية- كجهة تسجيل- ووزارة الاختصاص كجهة اشراف ومتابعة.
واليوم يكمل الحمدلله ما تم البدء فيه فيما يتعلق بقانون الشركات غير الربحية، حين صادق بتاريخ 7 يوليو 2015، على تعديل لنظام الشركات غير الربحية، وجعل مجلس الوزراء مرجعية لتحديد مصادر دعم هذه الشركات وأوجه الصرف فيها- فيما يرى المحللون أنه يستهدف سلام فياض وشركته غير الربحية بعد أن ترك مربع الحكومة وانضم لمربع المجتمع المدني، ويبدو انه سيكون من أوائل من سيدفعون ثمن التغول الجديد على المؤسسات، هذا التغول الذي أسس له أثناء حكمه!
ويبدو أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لن تسلم من قرارات الجلسة (59) لمجلس الوزراء الحالي، الذي قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة الإطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية تحت شعار تطوير قدرة وزارات الاختصاص على متابعة شؤوون الجمعيات.. يعني لن يسلم أحد من القرارات الجديدة بغض النظر عن شكل التسجيل.
ليست شماتة فبما يتعرض له رئيس الوزراء الأسبق، وليست مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي قام باتخاذها وندفع ثمنها كمجتمع مدني ومجتمع فلسطيني ككل، بل هي رسالة تحذير للمجتمع المدني الذي اختار الصمت في كثير من الأحيان، وقبِل الاحتواء في أحيان أخرى.
سلام فياض استقال وغادر –كعادة كل المسؤولين الفلسطينيين- ولم يعتذر للشعب الفلسطيني عن أي من سياساته ولو تحت غطاء "أنني اجتهدت وقد أكون مخطئاً" ولن يعتذر للمجتمع المدني الذي أصبح جزء منه ويدفع معه ثمن السياسات الأمنية والحلول الأمنية، ليصبح (أي سلام فياض) نسخة من كل من سبقوه وسيأتون بعده، ولا عزاء للناس!
[نشر المقال على شبكة "نوى" ويعاد نشره بالاتفاق مع الكاتبة]
![[\"???? ????. ?????? \"?????????]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/341px-Salam_Fayyad_(cropped).jpg)